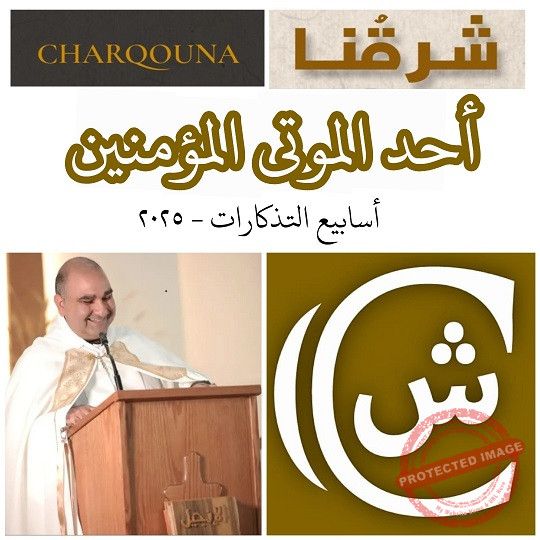الخوري نسيم قسطون:
في حياتنا اليوميّة، نعيش واقعًا مزدحمًا بالأحداث والهموم، وننسى أحيانًا أنّ خلف هذه الحياة الزائلة تكمن حقيقة أبديّة تتجاوز حدود الزمن والمادّة!
حدث الموت الّذي يبدو كالنهاية في أعين البشر، هو في الواقع تحوّل يقودنا إلى لقاء مع جوهر وجودنا. إنّه اللحظة التي تُختبر فيها حقيقة ما عشناه وما آمنّا به.
في المجتمعات البشرية، غالبًا ما ظهر الانقسام بين من يؤمنون بالحياة الآخرة وبين من ينكرونها كما انقسم اليهود، في زمن ربّنا يسوع، بين الصدوقيّين الّذين أنكروا القيامة والحياة الأبدية، وبين الفريسيين الذين آمنوا بها.
من هنا، لا بدّ من العودة إلى الكتاب المقدّس الّذي يقدّم لنا رؤيةً روحيّةً تتعامل مع الموت ليس كخاتمة، بل كبوابةٍ نحو حياةٍ أبديّة.
في ضوء هذا الواقع، نتأمّل اليوم في مصيرنا الأبديّ من خلال مثل الغني ولعازار (لوقا 16: 19-31)، حيث تتجلّى المفارقة بين واقع الحياة الأرضيّة والحقائق الأبديّة إذ نجد فيه دعوة واضحة موجهة إلى كلّ إنسان ومفادها أنّ قيمته لا تُقاس بما يملك، بل بما هو عليه!
في هذا المثل، نرى الغنيّ الذي عاش حياة الرفاهيّة والترف، غارقًا في ملذّاته غير مكترث بمن حوله، بينما لعازار، الفقير الملقى عند بابه، يعاني الجوع والألم. بعد الموت، تنقلب الأدوار؛ الغنيّ يجد نفسه في العذاب، بينما لعازار ينعم بالراحة في حضن إبراهيم. هذه الصورة ليست عقابًا للغنى في حدّ ذاته، بل إدانة للّامبالاة وانغلاق القلب. فالغنيّ لم يُدان بسبب ثروته، بل بسبب تجاهله لإنسانيّة الآخر.
هنا، تكمن رسالة جوهريّة: الحياة الأبديّة ليست امتدادًا لحياة الترف أو الشقاء، بل هي نتيجة الخيارات التي اتّخذناها في حياتنا اليوميّة. فالإنسان الذي يغلق عينيه عن معاناة الآخرين، ويكتفي بدائرة مصالحه الشخصيّة، يُخاطر بأن يجد نفسه محرومًا من فرح الملكوت. في المقابل، من يفتح قلبه للمحتاجين ويمنحهم من وقته وحنانه قبل عطاياه المادّيّة، يدخل إلى عمق الحياة الحقيقيّة التي لا تنتهي.
إنّ لعازار، في هذا المثل، ليس مجرّد فقير عاش في زمنٍ مضى، بل هو رمز لكلّ شخص يئنّ تحت وطأة الحاجة والألم في مجتمعاتنا. قد يكون لعازار عجوزًا مهمَلًا، أو مريضًا ينتظر زيارة، أو شابًّا يبحث عن معنى لحياته وسط الإحباطات. وجود لعازار في حياتنا ليس اختبارًا لقدرته على التحمّل، بل اختبار لرحمتنا وإنسانيّتنا. إنّ القيم التي نبني حياتنا عليها، كالمحبّة والرحمة والعدل، هي ما يبقى لنا حين تعبر أرواحنا إلى الضفّة الأخرى.
غير أنّ هذا المثل لا يتوقّف عند دعوةٍ للرحمة فحسب، بل يحمل في طيّاته نداءً للثقة بالله وبالحياة الأبديّة.
في زمنٍ باتت فيه المادّة هي المقياس الأوّل للنجاح، يذكّرنا الإنجيل بأنّ ما نراه بعيننا ليس الحقيقة الكاملة. فالموت، وإن بدا كخسارة، هو بداية لحياة أخرى حيث العدالة الإلهيّة تُنصف من عانوا بصمت ومن أحبّوا دون مقابل.
إنّ الإيمان بالقيامة ليس مجرّد قناعة عقليّة، بل هو نور يبدّد خوفنا من الموت، ويجعلنا نعيش الحاضر بشجاعة. فحين نؤمن أنّ هناك حياة بعد الموت، نبدأ بالنظر إلى الآخرين كأخوة في مسيرة واحدة نحو الأبديّة. هذا الإيمان يحرّرنا من الأنانيّة، ويدفعنا لنبحث عن لعازار في محيطنا، ونمدّ إليه يد العون قبل فوات الأوان.
كذلك، تعلّمنا الصلاة أن نبقى على تواصلٍ مع أولئك الذين سبقونا إلى الحياة الأبديّة. ليست الصلاة للموتى عادةً جامدة، بل هي تعبير عن المحبّة التي تتجاوز الزمن، وعن الرجاء الذي يُنعش قلوبنا حين نفقد أعزّاءنا. فالله إله أحياء، وليس إله أموات، وكلّ من يحيا في حضرته يظلّ حاضرًا في قلوبنا من خلال الصلاة.
حين نتأمّل في هذا المثل، نُدرك أنّ الغنى الحقيقيّ ليس فيما نراكمه من أموال، بل فيما نزرعه من محبّة في قلوب الناس. وأنّ الفقر الحقيقيّ ليس في قلة الموارد، بل في جمود القلب. من هنا، تنبع دعوتنا اليوميّة إلى أن نعيش كما علّمنا المسيح: بانفتاحٍ، وبمحبّةٍ، وبإيمانٍ بأنّ الحياة الأبديّة ليست وعدًا بعيدًا، بل هي حقيقة نزرع بذورها هنا والآن.
لذا، فلننظر حولنا ونسأل أنفسنا: أين لعازار في حياتي؟ هل أراه؟ هل أسمع أنينه؟ وهل أنا مستعدّ لمدّ يدي نحوه، لا بدافع الشفقة، بل بدافع الأخوّة الإنسانيّة؟ الإجابة عن هذا السؤال تحدّد، في النهاية، الطريق الذي نسير فيه بعد عبورنا هذا العالم الفاني.