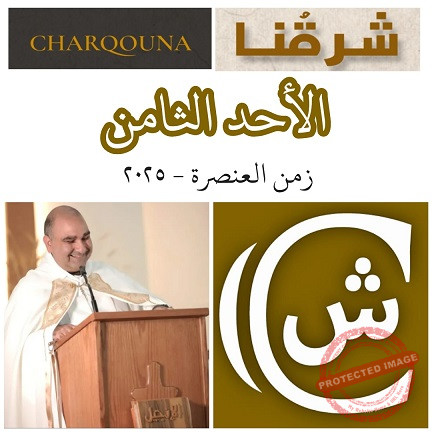الخوري نسيم قسطون:
شغل يسوع، في حياته على الأرض، أذهان الفريسيين والصدوقيين ورؤساء اليهود على حد سواء. فقد كشف زيفهم وتعصّبهم وهدّد نفوذهم ومكانتهم بين الناس، ما دفعهم إلى التخطيط والتآمر للتخلّص منه بكل الطرق والوسائل، وصولًا إلى الصلب الذي كان ذروة المؤامرة، حيث اجتمع من لم يعتادوا الاجتماع واتفق من لم يعتادوا الاتفاق. فكم من مرة يزعجنا يسوع في حياتنا المعاصرة، بتعاليمه السمحة التي تدعو إلى المحبة والصفح والغفران؟ ألا نتمنى أحيانًا لو كنا “أحرارًا” نفعل ما نشاء دون حسيب أو رقيب؟ باختصار، ألا نودّ أحيانًا “قتل” يسوع والتخلّص من إزعاجه لنا ولضميرنا؟
لقد انسحب يسوع مرارًا من الشر ومُسبّبيه، معلّلًا ذلك بقوله “لم تأتِ الساعة”. وفي هذا حكمة إلهية عميقة، لأن مواجهة الشر في توقيت خاطئ قد يقوّض مشروع بناء ملكوت الله. إنه ليس هروبًا، بل تصرفًا بفطنة وحصافة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحضير مواجهة أكثر فاعلية وقوة. فكم مرة نسقط في التجربة لأننا غير مزودين بالأسلحة الروحية الفعّالة، لأننا لم نصلّ كفاية، ولم نمتلئ من الله كفاية، ولم نفتح قلوبنا للروح القدس كفاية؟ ألسنا بحاجة للانصراف عن مكان أو زمان التجربة لئلا نقع في تجربة الغرور الروحي، فنعتمد على قدرتنا الذاتية، فتكون النتيجة سقوطًا مدويًا؟
في مقابل روح الشر لدى الفريسيين، نجد وصفًا ليسوع من خلال نص آشعيا الوارد في متى 12: 14-21، يفيض بصفات الوداعة والحلم والسلام. لقد رفض يسوع دائمًا مواجهة العنف بالعنف، والشر بالشر، بل استبدل منطق الانتقام “العين بالعين، والسن بالسن” بمنطق المحبة، بقوله “ومن سخّرك ميلًا واحدًا، فاذهب معه ميلين”، و”أحبوا أعداءكم”. إلى أي مدى نتشبه بالمسيح في علاقاتنا اليومية؟ إلى أي مدى نعيش السلام وسط عائلاتنا وأعمالنا؟ إلى أي مدى نمارس الحلم في مواقفنا المتشنجة وخلافاتنا؟
يسوع لم يتجسد ليؤسس مملكة قائمة على العنف، ولم يتألم ليجعل سواه يتألم، ولم يمت لأنه يريد لنا الموت، بل أراد لنا الحياة، ولم يقم منتصرًا لينتقم ممن عادوه. لقد أتى يسوع ليؤسس مملكة سلام، عرشها قلب كل إنسان يسعى لمد جسور التواصل والوئام مع ذاته ومع سواه، انطلاقًا من سلام قلبه المؤسس على العلاقة العميقة مع الله. غالبًا ما نسعى إلى الشهرة ونريد تحقيق نسبة كبيرة من المعجبين بأقوالنا وأفعالنا، ولكن أليس الأجدى أن نجعل الله أول المعجبين بنا؟
في مجتمعاتنا اليوم، نحن بأمس الحاجة إلى أناس يتمتعون بصفات المسيح. يسود العالم نوع من الاستسلام لنزعة العنف ولسيادة سوء التفاهم. لا يكاد يلتقي اثنان حتى يتحول حوارهما إلى جدال فخلاف، لأن كلًا منهما يتكلم دون أن يصغي أو يصمت، لا ليسمع بل ليحضر ما يستكمل به أطروحته. يشدد وصف المسيح في آشعيا على الطابع السلمي واللاعنفي لطبعه وسلوكه ورسالته، وخاصة في صورتي القصبة المرضوضة والفتيلة المدخنة. لم يأتِ المسيح إلى عالمنا ليدمّره بل ليحييه وليغيره من عالم غارق في دوامة الشر إلى عالم ينبض بالمحبة، وهو ما يدعونا الرب للقيام به لنكون رسل سلامه، نسلك بالمحبة وندعو إليها، ونكون قادرين، بنعمة الروح القدس، على عيش نعمة طلب الغفران ومسامحة من أخطأ إلينا.
يمكن للإنسان أن يقوم بفحص ضمير معمق من خلال هذه التعاليم. هل أنا واعٍ لكوني مختارًا من قبل الله؟ وهل أرضي من اختارني واصطفاني لأحمل اسمه إلى العالم؟ هل أترك لروح الله المجال ليعمل من خلالي فتصل كلمة الحق إلى الأمم، وأولًا لمن هم حولي؟ هل أثابر على رسالتي إلى أن ينتصر الله في حياتي وفي حياة الآخرين من حولي فيجعل الجميع رجاءهم في المسيح يسوع؟
في هذا السياق، نتأمل في السلام الذي حمله إلينا الرب، ونجد في مواجهته مدى الشر الذي يغرق فيه عالمنا أحيانًا. يسوع الذي “لن يماحك ولن يصيح، ولن يسمع أحد صوته في الساحات”، والذي “قصبة مرضوضة لن يكسر، وفتيلة مدخنة لن يطفئ”، سيواجهه الفريسيون بخطط لقتله. لا يفهم العالم أحيانًا أن الحرب لا تقود إلى سلام حقيقي، بل تغذي الحقد والكراهية والتمييز بين الناس، وخاصة بين الغالب والمغلوب. يدعونا إنجيل اليوم إلى التأمل بالرب وبسلامه، وإلى الابتعاد عن هوس بعض الناس بالعنف.
ما هو الأهم اليوم: التنظير من بعيد أم محاولة أن نكون مسيحيين حقيقيين؟ بدل التنظير، ما رأيكم أن يعوّض كل واحد منا بمسيحيته عن مسيحي يقع شهيدًا في مكان آخر؟ لنعطِ شهادة المسيحيين في كل الأماكن قيمةً عبر عيش مسيحيتنا فعلًا لا قولًا وتنظيرًا فقط.