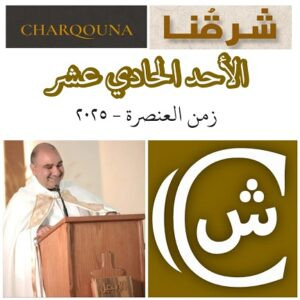الأب جوزف خليل-
ليست كلّ وجوه الظلمة صاخبة، ولا كلّ ملامح الشرّ مرعبة. فالشيطان في حكمته الشريرة، يدرك أنّ الأبواب لا تُفتح بالعنف، بل تُستدرَج حين تُقرَع بلطفٍ يُوهم بالبراءة هكذا يختبئ الخداع خلف عاداتٍ تبدو بريئة، ممارسات تُرتدى برداء المزاح، أو تُكسى حُلّة التقاليد، فتُعرض على الأرصفة، وتُتناقل في سهرات الليل، وتُقدَّم كألعاب أو طقوسٍ كأنها بلا ضرر، لكنها في حقيقتها أبواب نجسة تُفتح على مصاريعها لقوًى خفيّة تُشوّه صورة الله فينا وتفصل النفس عن نور نعمته.
فلا تنخدع بزينة الشكل ولا بطلاء العادة، لأنّ “الحيّة بغوايتها قد تفسد أذهانكم عن الإخلاص البسيط للمسيح” (2 كورنثوس 11: 3). فكما يحذّر السيّد، “يأتونكم بثياب الحملان، وهم في الباطن ذئاب خاطفة” (متى 7: 15).
في هذا الجزء، سنتناول موضوعًا خطيرًا منتشراً في مجتمعاتنا اليوم، لكنّه يُقسّم إلى قسمين متميزين:
القسم الأول، يتناول ظواهر مثل قراءة الفنجان بعد رشفة قهوة، أو تعليق الخرزة الزرقاء على الصدر، وهي ممارسات توهم البعض بالحماية أو الكشف عن المستقبل، لكنها في الحقيقة تقود إلى عالم الخفاء والشكوك، بعيدًا عن الله.
أما القسم الثاني، فيركز على ممارسات أخرى قد تبدو أكثر وضوحًا، كتعليق عجين ممزوج بالنقود على عتبة باب المنزل، أو نضوة حصان أو ربط حذاء في الجزء الخلفي من السيارة، طلبًا لبركة وحماية يعتقدها البعض موهومة. وليس الخطيئة في هذه الأفعال الظاهرة، بل في التعلّق القاتل بما تصنعه الأيدي، واستبدال الله الحي بالخوف والقلق والاعتماد على أدوات لا خلاص فيها.
في هذين القسمين، سنكشف كيف أن هذه العادات تشكل تهديدًا حقيقيًا لإيماننا المسيحي، وكيف يدعونا الرب إلى الاتكال عليه وحده، لا على رموز أو طقوسٍ باطلة، لكي نحيا في النور والحرية الحقيقية التي يمنحها المسيح وحده.
ما يُعرف بـ”التبصير في فنجان القهوة”، أي تأويل الرسوم المتشكّلة في قعر الفنجان بعد شرب القهوة، ليس مجرّد تسلية عابرة أو عبث بريء كما يُظنّ، بل هو انحناء خفيّ أمام أسرار الزمن في غياب الله، ومحاولة لسماع صوته من خلال الرماد لا النور.
كيف لمؤمنٍ وُلد من الماء والروح أن يُسلّم مصيره لبقع البنّ السوداء؟
وكيف يرضى، ولو على سبيل المزاح، أن يقرأ مستقبله في القهوة اليابسة، فيما هو ابنٌ لإله حيّ، كتب له اسمه على كفّ يديه، ويقود خطاه بالحبّ نحو الحياة الأبدية؟ (راجع أشعيا ٤٩: ١٦)
التبصير جهد بشري لتأليه الرغبة، ولتشريع سلطان الخيال على مشيئة الله. هو سعيٌ لسرقة مفاتيح الزمن من يد الربّ، والتسلّل إلى المستقبل من خارج مسكن النعمة. وما يُسمّى اليوم بـ”فكّ أسرار الحبّ والرزق”، إنّما هو فعل تجديفٍ مغطّى، فيه يتحوّل القلب من مذبحٍ خاضع لإرادة الله إلى مرآةٍ مظلمة، يسترق فيها الإنسان نظرات محرّمة نحو ما لم يُكشف بعد، مُستبدلًا الإيمان بالتنجيم، والثقة بالخوف، والسلام بقلقٍ لا يرتوي.
يذكّرنا القديس يوحنا الذهبي الفم بأن “من يسعى إلى معرفة الغد خارج الله، هو عبد لا ابن”، فكم بالحري إذا جعل الإنسان من فنجان القهوة نبيّه، ومن بقع البنّ كهنته؟ فالإيمان المسيحي لا يقوم على استباق الأزمنة، بل على السَّير في ثقة رغم العتمة، مُمسكين بيد الله وحده، مؤمنين بأن “السِرّ للربّ إلهنا، والمُعلَن لنا” (تثنية 29: 28).
التبصير هو تمرد على هذا السرّ المقدّس، وسعيٌ لاختراق الزمن خارج حضن الله. إنه شكلٌ من أشكال العرافة الصريحة، المرفوضة في تعليم الكنيسة، إذ تنبّه بوضوح: “اللجوء إلى العرّافين، أو إلى المنجّمين، أو قراءة الكفّ، أو تفسير الفأل، أو الظواهر، أو اللجوء إلى وسيط، أو إلى تحضير الأرواح، كلّ ذلك يُخفي إرادة سلطان على التاريخ، وعلى الآخرين، وفي الوقت عينه رغبة في الاستعانة بالقوى الخفيّة. وهو يتعارض مع التكريم الواجب لله وحده” (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، §2116). فالرجاء المسيحي لا يقوم على ما يُكشف في قعر الفنجان، بل على ملء الزمان بيسوع المسيح، الذي بيده وحده مفاتيح الحياة والموت، والزمن والقيامة.
من يظنّ أنّ قراءة الفنجان “مجرد مزاح”، أو يعتبرها عادةً فُكاهية لا تُلزم، إنما يُدير وجهه عن الله، ويُسلّم قلبه لأوهامٍ تتنكر بثوب التسلية. لا يدرك أنه، ولو عن غير وعي، يفتح عقله وسمعه وقلقه لكلماتٍ تُغذّي الخيال، وتزرع الوهم، وتشويه صورة الله في داخله.
هذا اللعب بالنار الروحية لا يمرّ بلا أثر: فهو يُنبت صورة زائفة عن الله، وحياة مُزيفة، ورجاء كاذب، لأنّه يُبدّل الحقيقة الإلهية بأكاذيب بشرية تتلصّص على الزمن وتدّعي معرفة الغيب.
فالله كما قلنا سابقاً، لا يتكلّم عبر “خطوط اليد”، ولا يُفصح عن مشيئته من خلال “بقع البنّ”، ولا يُبشّر بخلاص الإنسان عبر بصمات تُفسَّر على جدران فنجان.
الربّ لا يُستَشفّ في بقع البن الناشف، بل في الكلمة؛
لا يُرى في رواسب القهوة، بل يُعلِن ذاته في عمق الإنجيل، في الأسرار المقدّسة، في صوت الكنيسة، وفي نار الصلاة والصمت، وفي صليب الأيام العادية حيث نتربّى على الإيمان، والصبر، والرجاء.
أي مسيحي يستبدل هذا الصوت الإلهي العميق بوشوشات الفنجان، إنما يختار أن يُغشي سمعه ويعتم بصره، فيتخبّط في ظلال أكاذيب ملوّنة، تخفي وجه الحقّ، وتشوّه صورة الإيمان المسيحي في أعماقه، فيغدو غريبًا عن صوت الراعي، ويتبع أفكار غرباء، يتكلّمون ولا يعرفونه، يَعِدونَه ولا يُخَلّصونَه، يزرعون فيه خوفًا بدل السلام، وغرورًا بدل الرجاء.
أمّا “الخرزة الزرقاء” وما شابه من أحجار أو رسومات (كالعيون، أو اليد المفتوحة، أو الأحرف المبهمة…) فهي أشكال وثنية جديدة تُنسب فيها القوة لأشياء مادية لا تصدر عن الله، بل عن “طاقة” مزعومة أو حماية كاذبة. تُعلّق في العنق، أو تُعلّق في المنازل والسيارات، كما لو أنّها تردّ الحسد والشرّ.
لكنّ هذه الرموز لا تمتّ إلى الإيمان المسيحي بصلة، لأنّ الشرّ لا يُقهَر بالتمائم أو الشعوذات، بل بصليب المسيح المقدس، “رأس كل سلطان وسلطة” (كولوسي 2: 15).
المسيحي الحقّ، لا يخاف من “العين”، بل يثق تمامًا أنه يسير في نور الرب، وأن إبليس وملائكته يفرّون عند إشارة الصليب. كما يقول المزمور: “الربُّ حافظك… لا تخف من هول الليل، ولا من سهم يطير في النهار” (مزمور 91: 5-6)، و”يحفظك الربّ من كلّ شرّ، يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الأبد” (مزمور 121: 7-8).
الاعتماد على هذه الرموز هو انحدار روحي خطير، يمنح الجماد قوة كاذبة، ويوهم النفس بأنّ الحماية تأتي من الحجر لا من الله ومن صلته به. هذه الوهمية تُبعد الإنسان عن العلاقة الحقيقية مع الله، وتجعل منه أسيرًا لأوهام باطلة، تفصله عن وجه الربّ.
الأشد خطورة أن هذه الرموز تغرس في النفس وهمًا بأنّ الحماية تأتي من الخارج لا من الله.
فالطفل الذي تُعلَّق له “خرزة زرقاء” يتربّى منذ صغره على قناعة باطنة بأنّ البركة تُعلَّق ولا تُستمدّ من الرب.
والعائلة التي تضع “حذاءً مقلوبًا” على الباب، خرزة زرقاء، أو تعلّق الحذاء في السيارة، تُربّي أبناءها، ولو عن غير قصد، على منطق السحر لا على منطق الإيمان. وهكذا تتحول البيوت، بدل أن تكون كنائس صغيرة تفوح منها ثقة الحامي السماوي، إلى حصون مشدودة بالخوف والخرافات الموروثة: خوف من “العين”، “الطاقة السلبية”، و”العين الحاسدة من فلان وفلان”…
ولا بدّ من الإشارة إلى العبارات الشعبية التي تكشف هشاشة الإيمان: “حطّينا خرزة زرقا من باب الاحتياط”، “ما بتضر أبداً”، “إيماننا قوي بس الحذر واجب”، “منآمن بالرب بس العين ما بتعرف شو بتعمل”… جميعها تبريرات تَكشِف ضُعف الإيمان وتفضح ضعف الثقة بالله. الإيمان الذي يخلط اسم المسيح مع هذه الطقوس، هو إيمان مشوّه يحتاج إلى تطهير عميق وتوبة صادقة.
الكنيسة، بسلطانها المقدّس وتعليمها الرسوليّ، لا تساوم في هذه القضايا، لأنّها لا تتعلّق بمجرّد عادات موروثة أو طقوس شعبيّة، بل بانحرافات روحيّة تهدّد جوهر الإيمان المسيحي. فاللجوء إلى وسائل رمزيّة أو غامضة لكشف الغيب أو لطرد الشرّ، عوض الاتكال على الربّ وممارسة الأسرار، يُعدّ خطيئة مميتة ضدّ الوصيّة الأولى. ليس الأمر مجرّد بديلٍ خاطئ، بل خيانة للثقة البنويّة التي يدعونا إليها الله الآب، وانفصال خطير عن نور الإنجيل.
ذلك أنّ تعليق خرزة، قراءة كفّ أو فنجان، طلب حماية من رموز لا تنبع من الله، هو في جوهره سقوط في وهم استقلاليّ عن العناية الإلهيّة، وتمرد ناعم على سيادة الله على الزمن والقدر والمصير.
إنّه تسليم القلب إلى قوى غريبة، في محاولة لامتلاك المستقبل بدلاً من تسليمه بثقة إلى من بيده مفاتيح الحياة والموت.
لذلك، يعلّم التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بكلّ وضوح: “كلّ أشكال العرافة مرفوضة: استحضار الشيطان أو الأرواح، استشارة الموتى، تفسير الطالع، قراءة الكفّ أو الكواكب… إنّها جميعًا تُخفي رغبة في السيطرة على الزمن، وعلى الآخرين، وعلى العلاقات البشريّة. وهي على تناقض مع ما لله…” (§2116).
فالإنسان الذي يُسلّم ذاته للتبصير في الفنجان، أو لتعليق الخرزة الزرقاء، وكلّ ما يُلبَس ثوب البركة والحماية خارج نطاق تعاليم الكنيسة والوحي الإلهي، وإن عن جهل أو بحسن نيّة، إنّما يتنازل عن كرامة البنّوة، ويُبدّد مواهب الروح، ويقتلع ثقته من الله ليُسقطها على ما ليس هو. فيستبدل الرجاء المُؤتَمن على العناية الإلهيّة برجاء زائف، هشّ وعقيم. وهذا الانحدار ليس مجرّد هفوة شخصيّة، بل جرحٌ في صميم الإيمان، لأنّه يُنكر ضمنًا أن الربّ يعتني بنا، ويُهين سرّ الصليب الذي هو “قوّة الله للخلاص لكلّ من يؤمن” (1 كورنثوس 1: 18).
وهنا، نبلغ العمق الثاني لهذا الجزء، سنتداوله في القسم الثاني، إذ يتحوّل الخوف من مجرّد هاجسٍ داخليّ إلى ممارسات ملموسة نغرسها في بيوتنا، نعلّقها على أبوابنا، نربطها بأجسادنا، ونحملها معنا في مسيرنا اليوميّ.
فبعد أن تأملنا في رموزٍ كالفنجان والخرزة الزرقاء، ننتقل الآن إلى مظاهر أخرى لا تقلّ خطرًا:
تعليق العجين الممزوج بالنقود، نضوة الحصان، والحذاء في آخر السيارة.
ممارسات أخرى من الوثنيّة تتسلّل إلينا باسم العادة، وتتنكّر بثوب البركة، فتخدّر الضمير، وتُقصي الله عن مركز الثقة، وتغرس في القلب طمأنينة زائفة، تُبنى لا على الإيمان بل على الخوف، ولا على النعمة بل على أدوات صنعها الإنسان بيديه، ثم عبدها دون أن يدري.