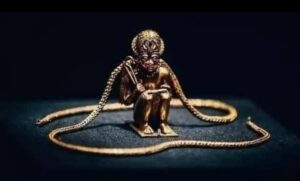في إحدى الكنائس الأثريّة الواقعة في جبّانة البجوات في الواحات الخارجة بمصر، والتي تعود إلى القرن الخامس الميلادي، نرى في الشرقية بقايا ثلاث صلبان مرسومة على هيئة علامة “عنخ” المصريّة القديمة، والتي تعني “الحياة” في اللغة والرمزيّة المصريّة القديمة.
يُجسّد هذا التصميم امتدادًا للاهوت الإسكندريّ الأصيل، حيث لا يُنظر إلى علامة الصليب كرمز للموت أو العار، بل كعلامة فرح وحياة وانتصار. ولهذا أصرّ الفنان على استخدام “العنخ” – رمز الحياة – بدلاً من الأشكال التقليديّة الأخرى للصليب، والتي وُجدت أيضًا في آثار المنطقة ذاتها، لكنّها لم تُستخدم في هذه الكنيسة بالذات، نظرًا لطبيعتها الجنائزيّة، وكونها تقع وسط الجبّانة، فهي تسعى لتأكيد معنى الحياة بعد الموت.
يمتدّ هذا المعنى أيضًا إلى الثالوث القدّوس، إذ إنّه حياة بذاته، وغاية التدبير الإلهيّ هي أن تدخل الخليقة في شركة ووحدة كاملة مع الثالوث. يقول الربّ يسوع: “إن أحبّني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبّه، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلًا” (يوحنا 14: 23). من هنا، يظهر اهتمام الفنان في الشرقية بإبراز الصلبان الثلاث كعلامات للحياة، وليست للموت.
الكنيسة: مسكن الله مع الناس
الكنيسة، باعتبارها جسد المسيح، هي أيضًا مسكن الله مع البشر. وتقوم علاقات رمزيّة عدّة بين الكنيسة وجسد الإنسان، إذ إنّ الكنيسة كيان حيّ، يسكن فيه الثالوث القدوس، مثلما يُقيم الله في الإنسان.
تميّز الصليب الأوسط في الشرقية بإضافة حرفي “الألفا” و”الأوميغا” – أي “البداية” و”النهاية” – استنادًا إلى سفر الرؤيا (الإصحاح 22: 12-13):
“ها أنا آتي سريعًا، وأجرتي معي، لأجازي كلّ واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأوّل والآخر.”
فإذا كان الله الآب قد سلّم الدينونة للابن، فإنّ الصليب الأوسط يشير إلى أقنوم الابن، الذي هو البداية والنهاية، وهو من نفس جوهر الآب.
الصليب الأوسط وموقعه اللاهوتيّ
لم يكن توزيع الصلبان الثلاث اعتباطيًا، بل إنّ المسافات المحسوبة بدقّة توحي بقصد فنيّ ولاهوتيّ، يؤكّد أنّها تمثّل الثالوث، لا صلبان اللصّين كما في التقليد الإيقونيّ المعروف. تمركز الصليب الأوسط في مقابل المذبح، يُشير إلى الذبيحة – جسد الرب ودمه – وبهذا، أراد الفنان أن يضع أقنوم الابن في قلب المشهد، لأنّه الذبيحة والظهور الإلهيّ المنظور.
الابن، الأقنوم الظاهر، هو الذي رأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا، كما تقول الرسالة الأولى ليوحنا. هو أيضًا مَن تُوجّه إليه أغلب الصلوات الليتورجيّة، بل إنّ اللاهوت الإسكندريّ أضاف نهايةً فريدة إلى الصلاة الربانيّة: “بالمسيح يسوع ربنا…”، انسجامًا مع القول الكتابيّ: “لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي” – فهو الطريق إلى الآب.
الثالوث والتجريد الرمزيّ
رغم وجود رسوم لأشخاص في نفس الحقبة والموقع، فإنّ الفنان لم يصوّر الثالوث كأشخاص (كما في أيقونة روبليف لاحقًا)، بل اكتفى بالتجريد الرمزيّ، إذ إنّ مفهوم “الأقنوم” لم يكن قد تبلور بصيغته الفلسفيّة الدقيقة بعد. فالكلمات اللاهوتيّة مثل أقنوم (Hypostasis) استُعيرت لاحقًا من التراث الفلسفيّ اليونانيّ، في مواجهة الصراعات العقائديّة، لتوضيح سرّ الثالوث.
الدكتور جوزيف موريس فلتس
أستاذ العلوم اللاهوتيّة وآباء الكنيسة