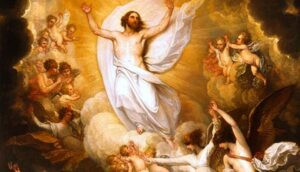نظام مارديني –
أطلقَ انهيارُ الاتحاد السوفيتي عام 1991 نقاشًا عالميًا واسعًا حول طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها النظام الدولي، حتى إنَّ بعضَ المفكرين ذهب إلى أننا دخلنا عصرًا “ما بعد أيديولوجي”، تراجَعَ فيه دورُ العقائد الكبرى لتحلَّ محلَّها صراعاتٌ براغماتية تقوم على حسابات المصالح والمنافع المباشرة. فـ”هل تكون الحداثة بديلًا عن الإيديولوجيات “المنخسفة”، أم العينَ المتنبّهة الدائمة التي تبقى يقظةً ولو بالتفاتات خافتة؟” كما يقول الباحث شربل داغر.
ولكنْ هذه الأطروحة، على الرغم من رواجها الإعلامي والسياسي، تخفي وراءها هشاشةً مفاهيمية عميقة؛ لأنها تتجاهل الطبيعة الأيديولوجية الملازمة للإنسان، وتفترض إمكانية تاريخٍ بلا أيديولوجيا، وهو ما يتعارض مع واقع كل التجارب التاريخية والفكرية للبشرية.
فالمجتمعات البشرية، بطبيعة تحوّلاتها، تفرز الإيديولوجيا كما لو كانت العنصرَ والمناخَ الضروريين لحياتها التاريخية. وبهذا المعنى، لا يمكن اعتبار الإيديولوجيا شذوذًا أو شيئًا زائدًا عرضيًا في التاريخ؛ إنها بنيةٌ جوهرية أساسية بالنسبة إلى الحياة التاريخية للمجتمعات. وإنَّ وجودَها والاعترافَ بضرورتها هما وحدهما اللذان يسمحان بالتأثير على الإيديولوجيا وجعلها وسيلةً واعية فعالة في التاريخ. وإنَّ الزعمَ بانتهاء الأيديولوجيا عقب انهيار المنظومة الشيوعية يقوم على افتراضٍ اختزالي، يرى أن سقوط تجربة سياسية – اقتصادية بعينها يعني أفولَ كل الأنماط العقائدية. غير أن هذا الزعم يواجه مأزقين:
مأزق التاريخ القريب: فما لبث أن حلَّت محلَّ الثنائية القطبية صراعاتٌ جديدة مشبعة بالأيديولوجيا، كما في أطروحة صموئيل هنتنغتون حول “صدام الحضارات” (1993)، التي مثَّلت تعبيرًا صريحًا عن رؤية أيديولوجية تعيد ترتيب العالم وفق خطوط الهوية الثقافية والدينية.
مأزق البنية الإنسانية: إذ يتجاهل هذا الطرح أن الأيديولوجيا ليست مجرد غطاء سياسي، بل هي ميلٌ أنطولوجي أصيل في الإنسان لإنتاج أنساق رمزية كلية تضفي المعنى والشرعية على أفعاله وتاريخه.
حتى كارل ماركس، الذي سعى إلى نقد الأيديولوجيا وفضحها باعتبارها “وعيًا زائفًا” – أي إنها تعبير عن نسق من الأفكار والتطلعات والأهداف الخاصة لدى الطبقة المسيطرة، والتي تسعى من خلال هذه الأيديولوجيا إلى تبرير مصالحها بصورة مزيفة – إلا أن ماركس لم يستطع الانفلات من البنية الأيديولوجية، إذ تحوَّلت الماركسية نفسها إلى أيديولوجيا شاملة.
منذ بدأ عصر الأيديولوجيا في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، مع تحطيم أساسيات التنظيم الإقطاعي الذي ساد خلال فترة العصور الوسطى، وظهور ثقافة التنوع أو التعدد، لا يزال المفهوم/المصطلح موضع خلاف بين العلماء والمهتمين بالأيديولوجيا السياسية. فأحيانًا يُستخدم على أنه سلاح، أو مجموعة من النصائح أو الإرشادات، وأحيانًا أخرى يُستخدم على أنه مجموعة من الأفكار الانتقادية لطبيعة النسق العقائدي السياسي ككل. وما زال من الممكن الدفاع عن الرأي القائل بأن القرن التاسع عشر كان عصرًا أيديولوجيًا؛ فلفظ “الأيديولوجيا” يعني، في أحد معانيه المتعددة، “التأمل النظري أو الفكري المجرد”. ويرى الباحث النظري الأمريكي في مجال علم النفس “دافيد ماكيلان” أن الأيديولوجيا كمفهوم يعد من أكثر المفاهيم المحيرة (Elusive Concept) في العلوم الاجتماعية ككل، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أساسية، منها: أن مفهوم الأيديولوجيا تدخل في تفسيره ظروف متعددة، ومن الصعوبة تحديده من الناحية النظرية والواقعية، وهذا ما يرتبط أساسًا بتحديد مفهوم الأفكار والمعتقدات، أو اعتباره جزءًا من السلوك السياسي والحياة المادية.
من جهتهم، يرى علماء الاجتماع السياسي أن الأيديولوجيا السياسية تتعلق بمعالجة قضايا تتصل بالحكم والإدارة وسياسة المجتمع، من خلال اهتمامها باختيار القادة وتحديد شخصياتهم ومجالات تخصصهم من ناحية، وكذلك الاهتمام بالحوار والجدل القائم بين وجهات النظر السياسية والاجتماعية المتعارضة التي تؤثر على سلوك وقيم أعضاء المجتمع.
وفي هذا الخصوص، يعتبر الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي (1891-1937) الأيديولوجيا نسقًا متكاملًا من الأفكار السياسية والقانونية والأخلاقية والدينية والفلسفية والعلمية، يوجّه السلوك ويحدد العلاقات وردود الأفعال في المواقف الاجتماعية المختلفة. وقد أوضح غرامشي أنه يعارض أي مفهوم للأيديولوجيا بوصفها “وعيًا زائفًا”، فهو لم يهتم بإمكانية زيف الأيديولوجيا بقدر ما اهتم بالوظيفة التي تؤديها. فالأيديولوجيا عنده تمثل تصورًا للعالم، تجسده عقيدة لا تحفز على التأمل النظري بل على العمل. ما يشير إلى أن غرامشي، الذي اهتم بالمجتمع المدني، أدى دورًا مهمًا في الخروج من قوقعة الماركسية التقليدية والحتمية الاقتصادية؛ فعلى الرغم من اعترافه بأهمية البنى القائمة، خاصة الاقتصادية منها، إلا أنه ركز على أهمية النظام الفكري ودور المثقفين في إنتاج الأيديولوجيا الثوروية. آمن غرامشي بأن الأفكار تبدأ من المثقفين ثم تنتقل إلى الجماهير، فلا تستطيع الجماهير في نظره تحقيق الوعي من دون مساعدة النخبة المثقفة، لكنها تبقى هي القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى أفعال.
خلال فترة طويلة استمرت حتى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، احتل مفهوم الأيديولوجيا مساحة متعددة المعاني، ولم يتداخل هذا إلى حد كبير مع اهتمامات علم الاجتماع الذي بلغ مرحلة النضج في أعمال الفرنسي “إميل دوركايم” والألماني “ماكس فيبر”، ووصل إلى ذروته مع عالم الاجتماع الأمريكي “تالكوت بارسونز”. وقد أدت الأيديولوجيا دورًا رئيسًا في النقاشات السياسية والأسئلة التاريخية المركزية، وغذّت النقاشات حول شؤون العالم، والصراع بين اليمين واليسار، والحرب الباردة… إلخ. حيث كان علماء الاجتماع مجرد فئة من المشتغلين في دراسة هذا الحقل من بين حقول معرفية أخرى. وهكذا، في المرحلة الممتدة من صياغة المصطلح حتى نهاية ثمانينيات القرن العشرين، كان علماء الاجتماع إما يبالغون في تقدير أهمية الأيديولوجيا وإما يقللون من شأنها.
صحيح أن غرامشي حرر الأيديولوجيا من الغموض واللبس وربطها بالبنية الفوقية، وميز فيها بين ما هو اعتباطي وما هو عضوي، إلا أن مفهوم الأيديولوجيا بقي مفهومًا إشكاليًا بامتياز، يحيل إلى عدد من المحطات التاريخية والتجارب الثوروية والتوظيفات المتباينة. بل إنه يتعرض لكثير من سوء الفهم والأحكام المتحاملة والتشويهات والعنف التأويلي، مما يستدعي الإبانة والتوضيح ورفع الالتباس الذي علق به، وفصل المقال حول تاريخ تشكله واستعمالاته. وقد اشتغل عدد كبير من الفلاسفة على الحقل الدلالي للأيديولوجيا، ومن أبرزهم “لويس ألتو سير” الذي تناولها من حيث ماهيتها وحضورها الكثيف في الأجهزة الأيديولوجية للدولة، في حين ربطها “كارل مانهايم” باليوتوبيا والمنظور، وكشف عن استحالة الاستغناء عنها في مستوى التخيل. وهذا يتعارض مع تحفظ “ميشيل فوكو” تجاه مصطلح الأيديولوجيا، لصعوبة استعماله نظرًا لتعارضه الضمني مع ما يُعد حقيقة، كما يقول!
أمَّا مارتن هايدغر فيذهب إلى أبعد من ذلك، حين أشار إلى أن الإنسان هو “الكائن المُؤطِّر للوجود”(das Ge-Stell)، أي إنَّه لا يستطيع إدراك ذاته والعالم إلا عبر منظومات تفسيرية ذات طابع أيديولوجي.
المفارقة هنا أنَّ البراغماتية، التي قُدِّمت في الخطاب السياسي الغربي بعد الحرب الباردة على أنها لغة “ما بعد الأيديولوجيا”، ليست سوى أيديولوجيا جديدة مقنَّعة. فالمصلحة والمنفعة ليستا مفهومَيْن طبيعيَّيْن محايدَيْن، بل هما نتاج رؤية معيارية تضع “المنفعة” في قمة هرم القيم.
وعادةً ما يربط الليبراليون الأيديولوجيا بما يسمونه أنظمة الفكر المغلقة التي تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة. فهم يزعمون أن الليبرالية مجرد مجموعة من المبادئ الفلسفية السليمة، في حين أن العقائد الأخرى – كالماركسية – هي أيديولوجيا. لكنَّ الباحثين يصنفون الليبرالية بدورها على أنها أيديولوجيا، والدليل على ذلك ما أعلنه الفيلسوف الأمريكي “فرانسيس فوكو ياما” في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”، من أن الديمقراطية الليبرالية هي النظام الأفضل الذي وصلت إليه البشرية.
وفي الكتاب المعروف بـ “الإيديولوجيا الألمانية” الذي ألَّفه “ماركس وإنجلز”، يوضح ماركس أن “هؤلاء الأشخاص، إذا بدوا في الإيديولوجيا مقلوبين على رؤوسهم، كما في الغرفة المظلمة السوداء لآلة التصوير، فإن هذه الظاهرة تنشأ عن مسار حياتهم التاريخي”.
في الختام، نرى أن إعلان “موت الأيديولوجيا” كان في حقيقته مجرد خطاب أيديولوجي جديد، يبرر هيمنة أنموذج سياسي – اقتصادي بعينه بعد الحرب الباردة. فالأيديولوجيا ليست مرحلة تاريخية يمكن تجاوزها، بل هي بُعد أنطولوجي في الوجود الإنساني، يلازم الإنسان ما دام يفكر ويمنح العالم معنى. ومن ثمَّ، فالتاريخ لم يدخل طورًا “ما بعد أيديولوجي”، بل يواصل إعادة إنتاج الأيديولوجيا في صورٍ وأشكالٍ متجددة، كلما تبدلت السياقات السياسية والمعرفية
نقلا عن مجلة البعد الخامس .